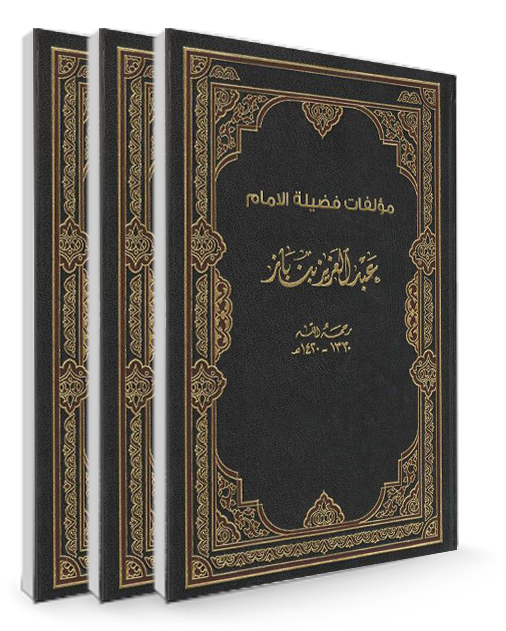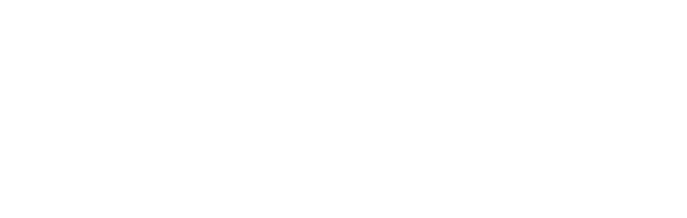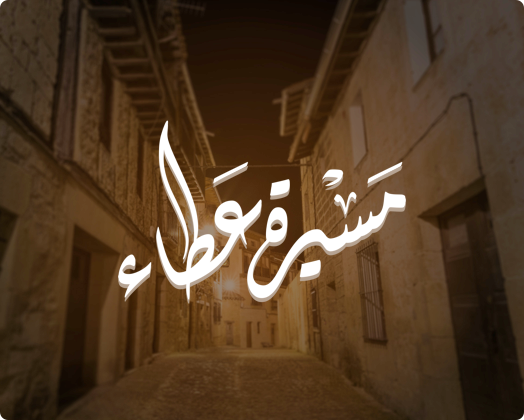الجمعة ١٠ / شوّال / ١٤٤٥
السؤال: الزلازل والبراكين والصواعق والفيضانات.. هل هي جند من جنود الله؟
الجواب: كل هذه الأمور وغيرها مما يحدثه الله في الكون، كلها تقع بقضائه وقدره وتدبيره؛ لحكم بالغة وغايات حميدة، يعلمها سبحانه وإن خفيت على كثير من الناس، ويعذب الله بذلك أقوامًا ويرحم آخرين، وله الحكمة البالغة في ذلك ، وفق الله الجميع[1]. أجاب عنه سماحته بتاريخ 17/ 12/ 1418هـ ونشر في مجلة الدعوة، العدد 1653، بتاريخ 14/ 4/ 1419 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 28/ 433).
228- باب استحباب صوم ستة من أيام من شوال 1/1254- عَنْ أَبي أَيوبِ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ. 229 - باب استحباب صوم الإثنين والخميس 1/1255- عن أَبي قَتَادَةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإثنين فقالَ:ذلكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنزِلَ عليَّ فِيهِ رواه مسلمٌ. 2/1256- وعَنْ أَبي هُريْرَةَ ، عَنْ رسولِ اللَّهِ ﷺ قالَ: تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يوْمَ الإثنين والخَميسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَملي وَأَنَا صَائمٌ رَواهُ التِرْمِذِيُّ وقالَ: حديثٌ حَسَنٌ، ورواهُ مُسلمٌ بغيرِ ذِكرِ الصَّوْم. 3/1257- وَعَنْ عائشةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهَا، قَالَتْ: كانَ رسولُ اللَّهِ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الإثنين وَالخَمِيسِ. رواه الترمذيُّ وقالَ: حديثٌ حسنٌ. الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد: فهذه الأحاديث في صوم ست من شوال والإثنين والخميس سبق أن الله جل وعلا إنما فرض علينا صوم رمضان، هذا هو الفرض على الأمة شهر في السنة فقط، وهو شهر رمضان وما سوى ذلك فهو تطوع وقربة إلى الله ، وأفضل ذلك أن يصوم يومًا ويفطر يومًا هو أفضل التطوع، صيام داود أن يصوم يومًا ويفطر يومًا، ويستحب صيام الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا ست من شوال لحديث أبي أيوب عن النبي ﷺ أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر رواه مسلم، هذا يدل على فضل صيام الست من شوال سواء صامها في أوله أو في وسطه أو في آخره، وسواء كان صامها متفرقة أو متتابعة فالحديث يعم الجميع. وكذلك الأحاديث الأخيرة في صوم الإثنين والخميس كلها تدل على فضل صيام الإثنين والخميس وهما يومان عظيمان تعرض فيهما الأعمال على الله فينبغي الإكثار فيهما من الخير، ومن الخير صيامهما، كان النبي يتحرى صومهما عليه الصلاة والسلام إلا أن يشغله شاغل، وربما سرد الصوم، وربما سرد الإفطار على حسب الفراغ والمشاغل، فالمؤمن يتحرى ما هو الأصلح، فإذا تيسر له الصوم صام، وإذا شغل عن ذلك لأمور أخرى فلا بأس، بعض العامة قد يعتقد أنه إذا صام هذا العام يلزمه دائمًا، لا ما هو بلزوم حسب التيسير، إذا صام الإثنين والخميس وأفطر بعض الأحيان أو صام ثلاثة أيام من كل شهر وأفطر بعض الأيام ما يضر، المهم أنه يتحرى هذا الخير ولو شغل عن ذلك في بعض الأحيان فلا بأس كله نافلة، لكن كون الإنسان يتحرى الخير ويجتهد في صوم الإثنين والخميس وست من شوال وثلاثة أيام من كل شهر ويكثر من ذكر الله ومن التسبيح والتهليل والتحميد، يكثر من قراءة القرآن، يتحرى عيادة المريض، الدعوة إلى الله، تعليم الناس الخير، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير هذا من وجوه الخير، هكذا المؤمن ينتهز الفرص ويجتهد فيستغل كل وقته فيما يرضي الله ويقرب إليه، في بيته، وفي طريقه، وفي المسجد، وفي كل مكان يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله وفق الله الجميع. س: ...؟ الشيخ: على ما جاء في الحديث: يغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول الله دعوا هذين حتى يصطلحا. س: ابن عمر ألم يتعبه صوم داوود؟ الشيخ: عبدالله بن عمرو كان في آخر حياته يشق عليه، وكان يفطر أيام ستة ويصوم أياما ستة ويقول: ما أحب أن أخل بشيء فارقت عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا عجز سرد الفطر ثم يسرد الصوم، وهذا من اجتهاده وإلا لو ترك الحمد لله الأمر واسع. س: ما ثبت عنه أنه قال ليتني أطعت وصية رسول الله ﷺ؟ الشيخ: يمكن ليتني قبلت رخصة رسول الله أظنه جاء عنه اجتهادًا منه، ما أحب أن يخل بشيء فارق عليه النبي ﷺ. س: ...؟ الشيخ: لا، بس من جهة الصوم قد يستغله أصحاب المولد وهذا غلط، إنما هذا من جهة الصوم وأنه يصام لأنه يوم بعث فيه وأنزل عليه فيه ويوم ولد فيه عليه الصلاة والسلام، فصار فيه فضلان: فضل كونه يوم مولده، وفضل كونه أنزل عليه الوحي فيه عليه الصلاة والسلام. س: صيام النافلة بعد انتصاف الشهر -شهر شعبان-؟ الشيخ: إذا ما صام النصف الأول لا يصوم بعد النصف إذا كان ما صام في النصف الأول. س:أي نافلة مطلقا؟ الشيخ: الصوم يعني إلا إذا كان يصوم الإثنين والخميس فيصوم ما في بأس، إذا كان من عادته يصوم الإثنين والخميس ما يخالف. س: أو البيض؟ الشيخ: البيض قبل النصف الأول. س: لو أخرها مثلا؟ الشيخ: لا، البيض في ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر هذه البيض. س: ... إلا بعد خمسة عشر شعبان؟ الشيخ: لا يبتدئ للحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. س: إذا صام يوما واحدا في النصف الأول من شعبان هل يصوم النصف الثاني؟ الشيخ: ظاهره لا بأس، إذا كان قبله شيء لا بأس أن يستمر، المقصود أن يصوم أكثر شعبان هذا المقصود أكثر شعبان. س: ...؟ الشيخ: إما أقله وإما أكثره. س: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ...؟ الشيخ: يتتبعون مجالس الذكر يصلون مع الناس الفجر والعصر. س: إذا كان الهجر يسبب شر...؟ الشيخ: لا لا، هذا الهجر الذي لأمور الدنيا لحاجاتهم، أما لأمر شرعي ما يدخل، مأجور صاحبه حتى يزول السبب، النبي ﷺ هجر كعب بن مالك وصاحبيه خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم وتابوا. س: ...؟ الشيخ: يبدأ من القضاء، القضاء أهم. س: من عنده دش يهجر؟ الشيخ: يستحق الهجر لأن الدش فيه شر كثير، لكن ينصح ويوجه إلى الخير. س:إذا كان رجا أنه يكف عن هذا؟ الشيخ: ينصح ويوجه إلى الخير ويقال له احذر هذا ولا تستعمل الدش، لعل الله يهديه، فيما بلغنا أن فيه شر كثير، أن فيه مرائي كثيرة خبيثة. س: متأكد شره؟ الشيخ: يستحق الهجر، من أظهر المعصية يستحق الهجر، هذه قاعدة سنة مؤكدة هجره. س: ...؟ الشيخ: لا ما يصير قاطع لأن هذا من السبب يقول ابن عبدالقوي رحمه الله: وهجران من أبدى المعاصي سنة وقد قيل إن يردعه أوجب وأكد وقيل على الإطلاق ما دام معلنًا ولاقه بوجه مكفهر مربد س: حتى ولو كان عمه مثلا ؟ الشيخ: نعم ولو أخوه أو عمه إذا كان أظهر المعصية. س: إذا كان يتمادى إذا قطع؟ الشيخ: إذا رأى مواصلة النصح جزاه الله خيرًا، إذا رأى أخوه أو عمه مواصلة النصح حتى لا يستمر لا يهجره بل يكون لقاءه له نصيحة ما هو بلقاء أنس ومحبة، لقاء نصح كلما لقاه نصحه ووجهه هذا من باب الخير، من باب التعاون على البر والتقوى.
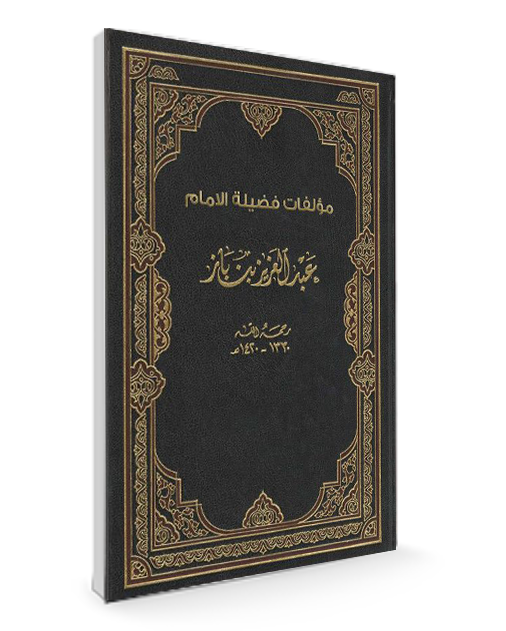 الأخلاق الإسلامية
الأخلاق الإسلامية
 أركان الإسلام
أركان الإسلام
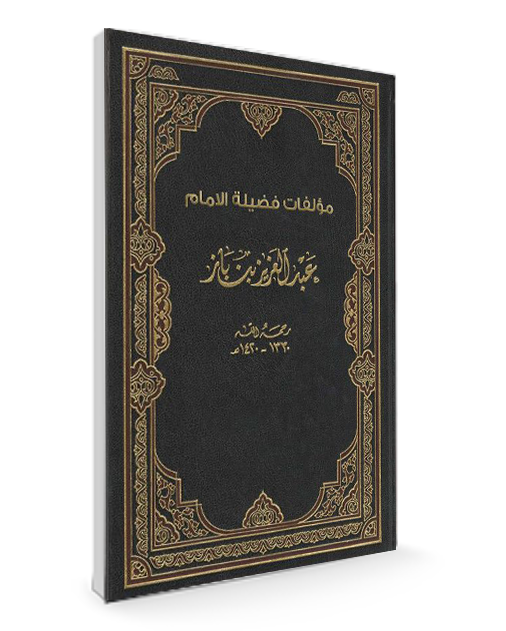 الأربعون البازية في العقيدة والعبادة والسلوك
الأربعون البازية في العقيدة والعبادة والسلوك